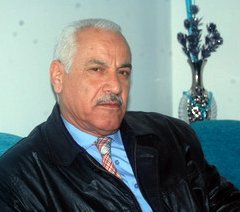أحـمـد الشـــــامـات
الدكتور حكمت الحلو
الدكتور حكمت الحلو
من الطقوس المحببة الى نفسي أن أذهب الى (المقهى البرازيلية) في شارع الرشيد كلما زرت بغداد، فقد كنت أخصص فترة الصباح لقضاء شؤوني الخاصة، أما عصراً فتجدني في هذه المقهى وكأنني أحد روادها المزمنين، وكنت أحرص كثيرا على أن أمارس ما كان أغلب مرتاديها يمارسه وهي أن أدلفَ اليها وتحت إبطي عدد من الصحف، أو كتاب أكون قد إلتقطتُه من أحد باعة الكتب على الرصيف في شارع السعدون أو ساحة التحرير، وقبل أن أجلس أضع علبة السجائر وولاعة الرونسون على المنضدة الصغيرة أمامي ثم آخذ مكاني على أحد مقاعدها المدهونة بطلاء يشبه لون القهوة المقدمة فيها.
وهذه المقهى ـ وعبر فترة طويلة من الزمن ـ قد إلتزمت بعض الضوابط التي لم تَحِد عنها الى هذا اليوم، فنادرا ما كنت تجد فيها مقاعد منفردة ما عدا تلك التي وضعت في واجهتها والتي كانت تفصلها عن شارع الرشيد واجهات زجاجية عريضة واسعة، فقد كان يحلو للبعض أن يجلس لوحده في مواجهة الناس والسيارات، أما الأماكن الأخرى فقد كانت مرتبة على شكل (حارات) تتشكل من ثلاثة أضلاع كل ضلع فيها يمثل أريكة طويلة تتسع لثلاثة أنفار، وهذه (الحارات) كانت ملتقى أدباء وشعراء وفناني العراق ورجال السياسة وقادة الأحزاب والصحفيين ورجال الأعمال من كل لون ومشرب، وكانت المساجَلاتُ والمناقشات تجري فيها حادة قوية حينا، ووادعة طريفة جذابة حينا آخر، ولذلك فإن أكثر ما كان يشدني إلى هذه المقهى أن أشاهد هؤلاء الناس (بشحمهم ولحمهم) ممن كنت أقرأ لهم أو أتابع أخبارهم عبر المذياع أو الصحافة عندما كان التلفاز محدود الإنتشار يومذاك فأحس بمتعة لا تدانى.
وذات يوم تموزي قائظ تناولت غدائي في أحد المطاعم القريبة من هذه المقهى، ثم إنتقلت إليها لأقرأ صحف اليوم وأنعش النفس بالقهوة المتميزة، ولأن الوقت كان وقت قيلولة فقد كانت المقهى شبه خالية إلا من بعض الذين كانوا يعبون الأرجيلة أو يحتسون القهوة أو يقرؤون الصحف، وما أن جلست حتى سلّم علي رجل ستيني أشيب جعلني أنتبه اليه من أول وهلة وأُبدي فيه إهتماما غامضا، جلس قبالتي في نفس الحارة التي أجلس فيها، فيما كنت قد بدأت بتقليب صفحات الجرائد التي كانت معي، لكنني كنت أختلس بين البرهة والأخرى نظرة خاطفة اليه وهو غارق يتأمل دخان سيجارته بعينين متعبتين، وفجأة انتفض من مكانه وأسرع خطاه بإتجاه رجل بدين أصلع كان يجلس غير بعيد عنا فإنتبهت اليه فإذا هو يشير بسبابته اليمنى الى هذا الرجل وهو يقول له:
ـ أنت حواس العجلوني ؟
ـ من أنت يا أخي ؟ وماذا تريد ؟
ـ أنا أحمد الشامات الفلسطيني .. هل تتذكرني ياحواس؟
وبدأ الإرتباك على الرجل وهو يحاول أن يتحاشاه
ـ لا يا أخي لا لست أنا، لعلك تُشبِّه أحداً ما بي ؟
ـ أقسم بالله إنك حواس، تَذَكرني يا حواس أنا أحمد الذي عملت عندك عام 48 في محلك لصناعة الأحذية في عجلون، هل نسيت ؟ أنا لا أريد منك شيئا إريد أن أعرف فقط هل أنت حواس فلدي سِرٌ ربما أجدُ له جواباً عندك.
لكن الرجل لم يُطِل الحديث معه وحاول أن يتفادى الموقف الذي هو فيه فخرج من المقهى بسرعة وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، فيما بقي صاحبي في نفس مكانه وهو يصفق كفاً بكف، ثم ما لبث أن عاد الى مكانه قبالتي، وعندما وجد في نظراتي إهتماماً وتساؤلاً قال لي:
هذا الرجل الذي كنت أكلمه إسمه حواس ابو غالية، أردني من عجلون، أعرفه تماما ولا يمكن أن تضيع ملامحه أوصورته من مخيلتي ما دمت حيا؛ وعندما وجد في نظراتي إليه ما يوحي بأني لم أفهم شيئا مما يقوله أو يَعنيه، قال لي :
ـ هل تسمح لي بأن أحدثك عن قصتي مع هذا الرجل ؟
ـ قلت : أسمح على أن أطلبَ فنجاني قهوة لي ولك
فقال وهو يداري تواضعه: لك ما تريد
ثم وضع ذراعيه الأشيبين على المنضدة التي تفصلني عنه وعبأ رئتيه بدخان اللفافة التي كانت ترتجف بين أصابعه وراح يحدثني عما جرى له مع حواس أبو غالية:
إسمي أحمد خليل الشامات ، فلسطيني من سكنة طوباس التابعة لمحافظة جنين والقريبة من حدود فلسطين مع الأردن، حصلت النكسة واحتُلت فلسطين من قبل الصهاينة عام 1948 وكان عمري يومها إثنتان وعشرون سنة، وكان قد مضى على زواجي خمسة شهور، وكنت قد ورثت عن أبي محلاً بسيطا لصناعة الأحذية فقد كنت وحيدهُ، وقد توفي قبل الإحتلال بأشهر قليلة وبعد زواجي بأيام عندما إنفجر كدس للبارود عليه وعلى عدد من رفاقه الذين كانوا قد أغلقوا محلاتهم البسيطة وإنضموا الى الثوار لمقاومة الإحتلال.
وقعت النكسة، وضاعت فلسطين بقرار دولي، وتشرد الفلسطينيون، وكان الإحتلال قاسيا ومريرا، والمؤامرة كبيرة، والخيانة بادية واضحة، لذلك فقد أصبحت مقاومة الإحتلال آنذاك بالنسبة لنا نحن الشباب الذين تحملنا هَولَ ما حصل ضرباً من الإنتحار، فليس بين أيدينا أبسط مقومات القتال ومقاومة المحتل، فقرر أغلبنا إنتظار ما ستؤول اليه الظروف، ثم نسعى بعدها الى إعادة تنظيمنا بعد أن نجد مصدرا ماديا أو معنويا يدعمنا، لذلك فقد عدت الى محل والدي وفتحته بأمل العمل فيه وتوفير مصدر عيش لي ولزوجتي ووالدتي، وكنت في ضيق شديد، ووضع مادي مُزرٍ، فقد عم الكساد وضرب كل مرافق الحياة قبل الإحتلال بسنة تقريبا ، ثم إستمر الى ما بعد ذلك ، وإزاء الضغط المادي الشديد الذي كنت أعيشه فإنه لم يكن أمامي إلا مَصاغُ زوجتي الذي كنت قد قدمته لها مَهراً قبل زواجنا ، وكان الأمل يحدوني أن تنفرج الأمور لأعوضها عنه ما هو أفضل وأكثر، لكني أتيت حتى على خاتَميّ الزواج ولم يبقَ لدينا شئ.
لقد كنت في مأزق نفسي كبير لاسيما أمام زوجتي التي لم ترَ مني غير إفلاسي وخيبتي وبطالتي ، مع أني كنت أسمع منها ما تحاول أن تهوّن به الامور لتخفيف صراعاتي وعذابي ، لكن الوضع يزداد سوءا ولم يبقَ أمامي إلا أن أبيع البيت وأسكن في بيت مؤجر لأتقوّت بثمنه مؤملا أن يأتي الفرج بعد هذه العُسرة والشدّة ، إلا أن أمي وزوجتي رفضتا هذه الفكرة بشكل قاطع لأن مجرد الإعلان عن بيعه فإن اليهود سيبادرون الى شرائه بأي ثمن وعند ذاك سأكون خائنا بطريقة أو أخرى لأهلي وعرضي ووطني ومسهما في تكريس الإحتلال وأنا ابن الشهيد الذي قضى من أجل وطنه ، وأنا الذي تطوعت مع الشباب من أجل درء الإحتلال، ولا زلت أتذكر كلام أمي التي قالت لي: لو حصل ما تقوله يا أحمد فإني بريئة منك ومن أمومتي لك ولا تتوقع مني أن أسكن معك أو أعترف بك؛ أما زوجتي فقد قالت لي بحدّة وثقة: قبل أن تبيع البيت يا أحمد عليك أن تطلقني، فلن أعيش مع شخص يبيع بيته لليهود المحتلين، وفي واقع الأمر فإني لم أكن أقل حماساً من أمي وزوجتي في الإحتفاظ بالبيت مهما غلا ثمنه ، لكنها فكرة راودتني فقلتها أمامهن تنفيساً للكرب الذي أعاني منه ؛ أما محل والدي فإن سبب تشبثي به فلأنني كنت آمل بإنصلاح الوضع لأقوم بفتحه والعمل فيه ، فهو مصدر رزقنا الوحيد ، كما أن بيعه لا يحل مشكلتي المادية فضلا عن أن أحدا لا يغامر بشراء دكان سيضطر لتركها مقفلة ولا يستطيع أن يستثمرها في أي شئ .
كان الشتاء شديد البرودة، والناس مذهولة مشدوهة لما حصل ، والعوائل قد توزعت وتشتتت بين المدن الفلسطينية، وهاجر الكثير منهم الى الدول العربية المجاورة، وإنقطعت أخبار من أصبحوا خارج الحدود عمن هم في الداخل، وكانت مجمل الأوضاع سيئة للغاية لا سيما أن اليهود الغزاة كانوا يستخدمون أساليب البطش والترويع تجاه الفلسطينيين بقصد إرهابهم وإجبارهم على ترك منازلهم والهجرة ؛ وذات ليلة كنت بين أمي وزوجتي أمام موقد الفحم المتوهج فقلت لهما : ما رأيكما أن أذهب الى الأردن فلعلي أتمكن من العمل هناك لفترة ثم أعود اليكما ؟ ولاقت هذه الفكرة على الفور ترحيب أمي وزوجتي ، واستنتجت بعد ذلك أنهما وافقتا على ذلك لإبعادي عن هذا الجو المشحون ، وخوفا عليّ من أن تدفعني الحاجة الى توريط نفسي في عمل أضيع فيه ، قالت زوجتي : أذهبُ الى أهلي حتى تعود الينا ، أما أمي فقالت أنا إمرأة كبيرة ولا خوف علي سأبقى في البيت ، ولي فيمن حولي من الأقارب والجيران ما يجعلك تطمئن يا بني فإذهب راشدا وتوكل على الله .
عند الصباح تلفّتُ في البيت علّني أجد ما أبيعه لآتي بالخبز لأمي وزوجتي، ولأضع في جيبي ما يمكنني من الوصول الى الأردن ، فلم أجد سوى بعض الأواني النحاسية فعبئتها في كيس كبير وبعتها لصاحب المخبز بثمن أعرف تماما أنه لا يساوي ربع ثمنها الحقيقي ، وأخذت الى البيت خبزا وبيضاً وأفطرنا ، ثم أخذت زوجتي وأوصلتها الى بيت أهلها ، وعند العصر كنت أمام أمي حيث ودعتها وغادرت البيت سالكا الشارع الوحيد المؤدي الى منفذ الصابرية الحدودي بيننا وبين الأردن ، وكان هذا الشارع لايبعد كثيرا عن بيتنا ، وإنتظرت حتى منتصف الليل في جو شديد البرودة ، وريح جمّدت دمي في عروقي وأنا أرتجف لساعات طوال حتى جاءني باص خشبي أضواؤه خافتة بالكاد تنير الطريق لمسافة قصيرة ، فوقفت أمامه ملوحا له ، فما كان منه إلا أن توقف ، وعندما إقتربت منه وفتح لي زجاج النافذة هبّت رائحة نفاذة رطبة لفضلات ماشية كان قد حشرها في الباص ، وسألته أن يأخذني معه الى المنفذ الحدودي فاستجاب لي ، وما أن ركبت معه حتى انهالت عليّ أسئلته ، لكنني كنت صادقا وصريحاً معه في كل ما سألني عنه وأخبرته أنني عندما سأنزل عند المنفذ سأتسلل ماشيا الى داخل الأراضي الأردنية لأنني لا أملك جواز سفر ، فتعاطف معي كثيرا ووعدني أن يسهل دخولي الى الأردن على أن أحشر نفسي بين الأغنام عندما نصل النقطة الحدودية .
إنبطحت بين الأغنام قبل الوصول الى المنفذ بقليل، وما أن وصلنا حتى ضغط السائق على منبه السيارة فخرج اليه شرطي يحمل فانوسا فسلم عليه واستلم منه ورقة وقربها من الفانوس ، ثم أمر السائق بالانطلاق ؛ ورغم أن بقائي بين الأغنام فترة لم تتجاوز سوى دقائق ألا أنني أعجز عن وصف ما حل بي خلالها وأنا في حالة إستسلام تام لمشيئة الخراف لا أستطيع أن أبدي أية حركة خوفا من إنكشاف أمري ، وما أن تحركت السيارة تاركة نقطة الحدود وراءها حتى هببت من مكاني ، ورحت أنظف ملابسي مما علق بها من مخلفات الأغنام ، ثم انتقلت الى مكاني جوار السائق ، ثم استأنفنا أحاديثنا تزجية للوقت وإبعادا لسلطان النوم عن السائق ، ووجدت أن من المناسب أن أسأله فيما يقترحه عليّ من مكان أنزل فيه يمكن أن يتوفر فيه العمل فأشار عليّ بالنزول في (عجلون ) باعتبارها مدينة كبيرة قد تتوفر فيها فرص العمل بشكل مضمون .
وصلنا عجلون مع إنبلاج الفجر ، وقبل أن أودع هذا الرجل الطيب مددت يدي الى جيبي بحثا عن نقودي لأدفع له أجره ، وعندما إنتبه وجه إليّ ما يشبه الأمر بالنزول وبطريقة فيها عتب واضح رافضا أن يأخذ مني أي شئ ثم ودعنا بعضنا بعناق حار ومصافحة بالغتُ فيها تعبيرا عن شكري وإمتناني لما قدمه لي من خدمة طيبة ونصيحة صادقة .
كان الجو باردا جدا ولفحتني لحظة نزولي من السيارة ريح شديدة البرودة ، فأسرعت الخطى ودخلت مقهىً صغيرا هو أول ما وجدته مفتوحا من حوانيت ودكاكين هذه المدينة ، وما أن دخلته حتى أحسست بالدفء يتسلل الى عروقي وعظامي فلقد توسط هذه المقهى موقد كبير تلتهم نيرانه قطع الخشب الموضوعة على جوانبه إلتهاما فتحيلها الى جمر متوهج يبعث الدفء والحرارة في المكان .
إحتسيت قدح الشاي برغبة وشهية ، وشعرت بلذته ورغم إحساسي بالجوع الشديد إلا أنني لم أكن أمتلك الرغبة في تناول الطعام ، ولم أفكر فيه ، وعندما شعرت أن دفء المكان قد بدأ يُرخي جسمي وأجفاني ويدفعني للنوم ، نهضت مسرعا وغادرت المقهى ورأسي يقول لي عليك يا أحمد أن تبادر في البحث عن العمل ولا مجال لإضاعة الوقت ، فضلا عن أنني كنت أشعر بتفاؤل غير عادي منذ أن إلتقيت بالسائق الطيب ولحد تلك الساعة .
تجولت في أسواق عجلون المسقوفة والمتداخلة مع بعضها ، ووجدت نفسي وسط سوق صناعة الأحذية ، وهو سوق صغير ومتواضع ، سلمت على صاحب أول محل وعرضت عليه الخدمة عنده ، لكنه أجابني دون أن ينظر الي " نحن عاطلون والسوق كاسدة تماما " فانتقلت الى المحل الثاني ، ولم يكن جوابه بأفضل من جاره ، وتواليت متنقلا بين هذه المحلات حتى وصلت محل هذا الشخص (حواس أبو غالية) الذي هرب مني الآن.
سألته العمل لديه فقال لي: هل تفهم في الكار ( أي الصنعة) ؟
قلت: نعم، فقال إجلس، ثم ناولني قالبا خشبيا وجلدا مخاطا وقال لي: ركّب هذه (الفردة) على القالب، فتاولتها ورحت أعالج تركيبها بمهارة من يجيد (الكار) فعلا ، وما أن بدأت بتثبيت الوجه على القالب بالمسامير الناعمة حتى أوقفني قائلا: أوافق على عملك معي ولكن أريد بطاقتك الشخصية ، ولم يكن أمامي من خيار إلا أن أكشف له حقيقة أمري كما هي، فأشار علي أن أبيت في حجرة صغيرة داخل المحل يتخذها لخزن المواد الزائدة عن حاجة المحل، كما طلب مني عدم الإحتكاك بالعاملين في السوق وأنه سيعمل على معاونتي لتوفير مبلغ أعود به الى أهلي بعد فترة قد لا تطول .
أمضيت في عملي قرابة شهر ، ثم دخل رمضان ، وإزداد ضغط العمل ، وواصلت العمل حتى في الليل، وعلى ضوء فانوس منهك، من أجل أن أوفر قرشا إضافيا ينفعني عند العودة قبل العيد كما وعدني حواس بذلك ، ولك أن تُقَدر حال واحد مثلي حبيس حجرة صغيرة لا يكلم أحدا في النهار ولا يرى أحدا في الليل، مقطوعا عن العالم تماما، غارقا بين قوالب الأحذية والجلود، وبين أفكاري والحوارات الداخلية التي كان يضج بها رأسي كلما تذكرت أمي وزوجتي ، وتحملت خلال هذين الشهرين عذابا نفسيا لا يطاق ، حتى إقترب العيد ، ولم يبق سوى أيام ثلاث ، فلقد خف العمل ، وتم تسليم البضاعة المنجزة الى أصحابها ، ولم يبقَ أمامي إلا التهيؤ للعودة ، وعندما عرضت الأمر على حواس أجابني بأنه لا يتمكن من دفع مستحقاتي لديه الآن وأن عليّ أن أنتظر الى ما بعد العيد ، فأخبرته بضرورة سفري قبل العيد وأن تكون هذه المستحقات معي وأنني بمسيس الحاجة اليها وقد هاجرت من بلدي وتحملت كل شئ من أجل أن أوفر مثل هذا المبلغ ، لكنه عندما وجد فيّ لجاجة وإلحاحا خيّرني بين السكوت أو تسليمي للشرطة ، وفي لحظات سريعة تراءت لي بعض الخيارات ؛ فإما أن أقتله وأهرب أو أن أسافر وأعود اليه بعد العيد، أو أن أبقى حبيس المحل طيلة العيد بأمل الحصول على مدخراتي لديه والبالغة أربعة وأربعون دينارا أردنيا، وفي لحظات قررت أن أعود لأمي وزوجتي فأقضي العيد معهما ثم أعود اليه فيما بعد.
كنت مشحونا بالأسى والغيظ والإحساس بالظلم والقهر ، ولأول مرة في حياتي وجدت نفسي ماشيا كالمجنون في أزقة عجلون وأنا أبكي بمرارة وألم غارقا في خيبتي وإحباطي لا ألوي على شئ ، لكن قرار الرحيل كان بالنسبة لي قطعيا ولا رجوع عنه .
سألت بعض المارة عن كيفية الحصول على سيارة يمكن أن تأخذني الى معبرالصابرية الحدودي ، فأشاروا عليّ بالوقوف في نهاية الشارع الرئيسي لمدينة عجلون فلعلني أحظى بمن يقلني معه الى حيث أريد؛ وكان المغرب قد أدركني وأنا صائم دونما سحور أو فطور ليومين متتاليين، فدلفت الى أقرب مسجد وأفطرت على ماء، ثم وجدت كدسا من التمر اليابس ملقىً في إحدى زوايا المسجد فتناولت تمرات مضغتها وصليت وخرجت على عجل مؤملا أن أجد من يأخذني معه الى الحدود أو ربما يدخلني الحدود معه كما وقع لي عند مجيئي .
جلست عند حافة الطريق يائسا مستسلما لقضاء الله وقدره وأنا أقلب ما جرى لي ، وكيف سأواجه أمي وزوجتي ، وماذا عساي أن أقول لهما بعد هذه الغيبة المرة عليهن وعليّ ، كان الليل حالكا والهدوء يلف المكان ، والمدينة تغرق في ظلام تام إلا من ومضات تظهر وتختفي للحظات ، وفجأة سمعت جلبة قوية أدركت معها أنها صوت سيارة قادمة فتهيأت واقفا وأخرجت منديلي لأومئ به للسائق ، وإقتربت السيارة وما أن رآني السائق حتى توقف، كانت سيارة حمل كبيرة، أسرعت الى السائق وسلمت عليه وأعلنت له عن رغبتي بإصطحابه الى الحدود، فأجابني أنه مستعد لذلك وإن رغبت الى فلسطين حيث وجهته ، ولكن قُمرة السيارة لاتستوعب أكثر من إثنين كانا يجلسان الى جانبه ، وخيّرني بين الإنتظار أو الصعود فوق لفافات الصوف، وقبل أن يكمل كلامه كنت فوق السيارة التي تحركت بنا ، فحمدت الله الذي أبعدني عن السائق ومن معه ، وعن تساؤلاتهم التي ربما تجلب لي المزيد من العناء والمتاعب، ووجت نفسي أيضا محظوظا في تلك اللحظات فما أن تحركت السيارة حتى إرتميت فوق الصوف متفاديا الأقتراب من حديد السيارة الذي يكاد أن يتداعى عليّ أو هكذا حسبته.
كانت عيناي شاخصتان الى السماء وأنا أفكر بحالي وبالأعذار التي سأضعها بين يدي أمي وزوجتي وأنا أقابلهما فجر العيد، كان في القلب لوعة وأسى، وفي النفس حيرة وحسرة، كنت مخنوقا تماما، وتمنيت لو أني أقدر أن أبكي فلعلي أتخلص من شعوري بالإختناق، لكني لم أتمكن من ذلك.
توقفت السيارة عن الحركة إلا أن محركها ما زال يدوي بقوة وعنفوان ، وسمعت السائق ينادي فعرفت أنه يقصدني فاقتربت من قمرته مستفسرا ، فقال لي : لقد عبرنا الحدود الآن وسأستمر حتى جنين ، فأين تريد أن تنزل ؟ فاخبرته برغبتي في النزول في طوباس فقال لي : حسنا ، كان الليل حالك السواد تماما ولم يكن مصباحَيّ السيارة سوى نقطتي ضوء ذابل وسط ظلام مخيف موحش لا يخترقه سوى جلبة السيارة وطرقعاتها من كل جانب، وفاجأني صوت السائق ثانية: اليست هذه طوباس؟ هيا إنزل، وقفزت على عجل وإقتربت منه واضعا يدي في جيبي لأدفع له أجرته لكنه حرّك سيارته وهو يقول لي: إذهب راشدا، وآدع لنا وأنت تصلي الفجر وصلاة العيد، كل عام وانتم بخير ، مع السلامة.
هل يعقل؟ أنا الآن في طوباس ولكن عليّ أن أمشي مسافة غير قصيرة لأصل الى بيتنا ، كنت غير مصدق لأي شئ، ولم يبقَ أمامي من هدف سوى أن أرى أمي وزوجتي وأعرض أمري عليهن وأفوض أمري الى الله ، فلقد كنت بحاجة ماسة جدا اليهما ؛ كانت خيوط الفجر قد بدأت بالظهور معلنة عن يوم جديد هو أول أيام عيد الفطر، ولم أكن بعد قد تحققت في أي إتجاه أسير وأي الطرق أقرب لي، كنت أمشي وجلبة السيارة ما زالت في رأسي، وشعوري بالإنهيار بسبب الجوع والسهر والتفكير، وفجأة قفز أمامي خروف ناصع البياض أخذ ببصري وجعلني أتباطأ لأعرف سِرّ هذا الخروف الغريب، وعندما وجدني قد توقفت أو أوشكت على ذلك إقترب مني وراح يتمسح بي بِوِد وألفة، وحينما وضعت يدي حول رقبته إنفلت مني بهدوء ماشيا أمامي وكأنه يوحي لي بأن أتبَعه ، فكلما خفّت خطاي بإتجاهه زاد من سرعته، وحينما كنت أتأخر عنه كان يلتفت إلي وكأنه يسألني عن سبب تأخري أو وكأنه يستعجلني للحاق به ، أحسست على الفور إن وراء هذا الخروف سرا مخيفا ، وأن عليّ أن أنتبه تماما لا سيما وأننا في ذلك الوقت كنا قد سمعنا الكثير عن قصص الجان والشياطين والحيوانات التي تتقمصها الأرواح الشريرة فتؤذي بعض الناس. كنت والخروف أمامي قد وصلت مشارف المدينة وبدت لي بيوتاتها البسيطة المتواضعة الأولى، وما أن إقتربنا من هذه البيوت حتى قفز الخروف بخطوات رشيقة وكأنه غزال ليدخل أحد البيوت، وعندما إنتبهت الى البيت الذي غاب فيه الخروف وجدت الباب الخشبي موصدا تماما، كنت وجلا وخائفا وأنا أقرأ في سري ما أحفظه من كتاب الله ، وأحث الخطى للإبتعاد عن هذا المكان ، وإذا بالباب يفتح ويخرج منه شيخ كبير ذو لحية بيضاء بادرني على الفور: الحمد لله على سلامتك يا أحمد، هل سمعت أذان الفجر يا ولدي ؟ وقبل أن أجيبه قال لي : تعال يا ولدي وخذ أمانتك ، سألته أية أمانة يا سيدي ؟ فقال لي : أربعة واربعون دينارا ، مستحقاتك لدى حواس أبو غالية ، وصعد الدم الى رأسي ، وشعرت أن غشاوة سوداء قد إنسدلت أمامي ، ولم أعد أقوى على الوقوف ، وشعرت بأن يدا قوية توقفني وتقول لي : هيّا يا بني فلم يعد بيننا وبين صلاة الفجر وقت ، ثم أشار الى باب البيت فخرج منه الخروف ، فقال لي : وهذا الخروف إذبحه اليوم وكل منه أنت وأمك وزوجتك ، ثم غاب عني بسرعة خاطفة ولم أسمع الا صوت الباب وهو يوصد .
جئت بأمي وذهبت الى زوجتي فجئت بها أيضا ، وكنت بين فترة واخرى أقترب من الخروف أتحسسه فإذا هو خروف عادي لا يختلف عما ألفناه من الخراف ، وكان عليّ أن أعمل بوصية الشيخ فقد ذبحته وأكلنا منه ، وفرحنا كثيرا إلا أن هذا السر بقي يشغلني طيلة النهار ، وما أن دنا العصر حتى إستأذنت أمي وزوجتي مدعيا أنني أحمل أمانة لأحد الأشخاص الذين إلتقيت بهم في الأردن ، وخرجت بإتجاه بيت الشيخ لأعرف سر وحقيقة ما جرى لي .
وصلت المنطقة، ووصلت البيت المقصود، وطرقت الباب أكثر من مرة، ولكن ليس من مجيب، ثم خرج أحد الجيران ليخبرني أن البيت مغلق منذ فترة طويلة ولا يسكنه أحد ، وتلفّتُ في المكان ، هنا وقفت أمام الشيخ، وهنا تحاورنا، ومن هذا المكان إنتشلتني يده المباركة القوية الواثقة لتوقفني، وليبعث في نفسي الواهنة المرتبكة الحائرة الثقة والأمن، وهو يربت على كتفي مسلما ومودعا.
عدت الى أمي وزوجتي وقصصت عليهما ما جرى فلقد كنت أحس بثقل كبير وأنا أحمل هذا السر الغريب. والآن ـ كما رأيت ـ وجدت حواس أبو غالية، إنه هو، كنت أتمنى لو أنه إعترف لي بشخصيته لأحكي له ما جرى فلعله يملك بعضا من جوانب هذا السر الغامض.
للعودة إلى الصفحة الرئيسة